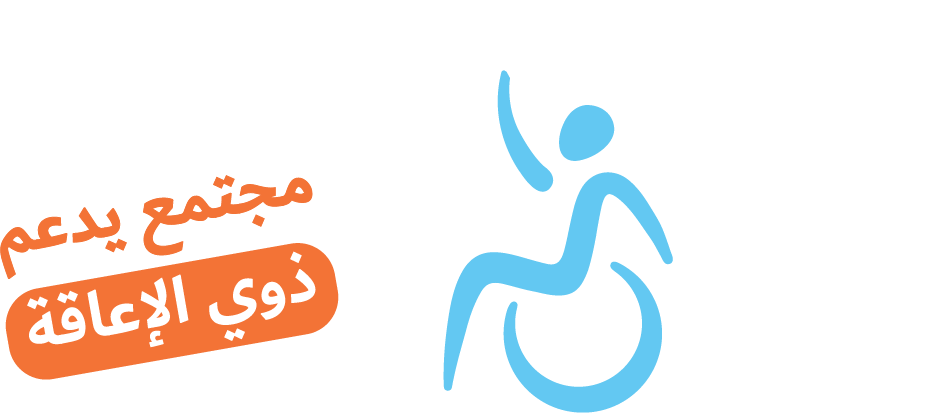«أنا أغنية طويلة ليس في مقدوري سماعها أبداً»، بهذه العبارة يُدخِلُ الكاتب السوري ريبر يوسف قرّاءه إلى عوالم «ي» بطل روايته الأصمّ، ففي الوقت الذي نرى الإعاقة البصرية حاضرة في بعض المؤلفات الأدبية العربية والعالمية، تندر الأعمال الأدبية التي تعالج فقدان حاسة السمع، ما يجعل رواية “المريد الأصم” عملاً يستحق وقفة خاصة، وإن كانت خصوصية العمل غير مقتصرة فقط على الموضوع الذي اختار معالجته.
الصمم في زمن الحرب
يتأمل الكتاب، الصادر عام 2021 عن دار ممدوح عدوان للنشر، بصورة أساسية في الصلة الخاصة التي تجمع الشاب ي بأبيه الذي يربيه بمفرده، والتحولات التي تشهدها العلاقة بين الاثنين في زمن الحرب ومع دخول الطفل عالم الشباب ومحاولته التحرر من خوف أبيه. يختار ريبر يوسف في كتابه تفكيك ظرفٍ مركّب، فبطله ي يواجه أيضاً تجربة الحرب للمرة الأولى، حربٌ يشعر بحضورها في جميع التفاصيل من حوله وإن كان يتعذر عليه سماع أصواتها.
أثناء القراءة يفطن المرء إلى أن للحربِ بعداً صوتياً، مسموعاً، يُساهم بتكريس سطوتها. فالطفل يرسم الطائرات على ورق كي يجردها من صوتها، والسجان يحاول انتزاع الصرخات والتوسّلات من المسجونين.
يستذكر ريبر يوسف في لقاء خاص معه ولادة فكرة كتاب المُريد الأصمّ، حينما كان يعمل عام 2016 في مطعم بمدينة كولن ودخل إلى مكان عمله مجموعة من الشباب: «كانوا في غاية الأناقة والخجل، وقفوا قبالتي ودفعوا صوبي ابتسامات سرعان ما تعلّقت على ركن الحيرة داخل عينيّ، ظننتهم سواحاً لا يجيدون الألمانية، واظبتُ لثوان قليلة على تفسير سبب صمتهم الساحر» يُعلّق ريبر على ذلك اللقاء، ويُكمل بأنه عرف فيما بعد بأنهم شباب فاقدون لحاسة السمع وهاربون من الحرب السورية. يبدو أن هذا اللقاء فتح في ذهنه -وهو الصَموت بطبيعته- العديد من الأسئلة وترك فيه أثراً عميقاً، أو كما يقول في كلماته: «ذلك المشهد أدار ذهني صوب ركنٍ من الطفولة، تماماً في الشارع الموازي لشارعنا، حيث كان يعيش طفلٌ أصمّ، أشيع عنه الجنون».
تحديات الكتابة بلسان من لا يسمعون
حول تحديات العمل على النص يرى ريبر أن المُريد الأصمّ وضعه أمام مجموعة أسئلة: « كيف أكتب رواية عن شخص أصمّ بدون حوارات؟ كيف أحوّلُ المشهدية في الرواية إلى حالة هامشية وأَعتمدُ بشكل رئيس على السرد التعبيري؟ كيف أقدّم علاقة الأب والابن عبر أدوات مختلفة، ومن خلال تفاصيل هامشية ودقيقة في آن، غير قائمة على أساس النقاشات الفكرية وغيرها؟».
في تطرقه للموضوع الذي يعالجه يبتعد ريبر يوسف تماماً عن المقولات الجاهزة، بل يذهب إلى أدق التفاصيل التي تشرح المعنى الحقيقي لأن يكون المرء أصمّاً، إذ يكتب في أحد مقاطع النص: «أتوجّس من تلك الغربة الدفينة داخل البشر إذ ينادون على الصُمّ بالأسماء، يبدو هذا مريباً حقاً، ما الجدوى من ذلك؟ لم يلتفت أصمٌّ قَط إلى مُنادٍ، ولم يلفظ اسمه في مكان ما». يجبرنا يوسف بذلك على إعادة التفكير في كل تفصيل مُعاش وفي كل المسلمات التي لا يتوقف عندها السامعون. أثناء تطور الحكاية يبني الكاتب أرشيف الأمور التي لا يسمعها الطفل ابتداءً من اللحظة التي تمتم فيها المصور «1، 2، 3» قبل التقاط صورته للمرة الأولى، مروراً بصوت مذياع الأب وهتافات الناس في الشوارع وأصوات الطائرات والقذائف، وصولاً إلى أصوات الجرس والطعام الذي يُطهى على النار.
الأصمّ كبطل عمل روائي
وعند سؤاله لماذا نجد أعمالاً أدبية تعالج فقدان حاسة البصر بينما تندر الكتب التي يكون بطلها شخصاً أصمّاً، يشاركنا ريبر بعض الأفكار الأولية حول هذا الموضوع، فهو يرى أن الشخص غير المُبصر يشاركنا لغتنا بخلاف الشخص الأصمّ، وعن هذا يقول: «الأصمّ يخلق مفاهيمه الخاصة بنفسه، والتي لا تشبه مفاهيمنا؛ يعيش ويفكر خارج سياق الإملاءات، مفاهيم مجهولة عنا نحن السمّيعين، لأنه يعيش اغترابه الأزلي الأبدي، يعيش خارج مؤسسة العائلة والحي والمدينة والدولة».
يعايش الكتاب المراحل التي عاشها الطفل حتى أدرك بأن هناك جزءاً مفقوداً من العالم حُرِّمَ عليه ولوجه؛ عالم الأصوات، حدث ذلك حينما فطن بأن حركة شفاه من حوله ليست مجرد حركة صادرة عن عضوٍ في الجسد بل هي وسيلة تواصل. في مواضع أخرى من الكتاب نرى الطفل-الشاب يغضب من الأصوات التي لا تلتقطها أذناه، ما يدفعه إلى تحريك الملعقة داخل كأس الشاي بقوة علها تخترق بذلك جدار الصمت وتصل إليه.
في الحوار معه، يضيف ريبر أيضاً أن الكتابة عن بطل أصم تفرض بدورها تحديات عديدة: «للكتابة عن الصُمّ، ينبغي فتح الأبواب التي أوصدناها عبر الزمن في وجوههم، أي، على الكاتب الدخول في مسار الكتابة التعبيرية، وهذا نوع صعب بتصوري، لأنه لا يملك حلولاً منجزة: مَن يُغامر بكتابة رواية ربما لا تُقرأ؟ لذلك، بقي الأصمّ مغترباً حتى كشخصية داخل رواية».
صرخة الأصم
إحياءاً ربما لذكرى الطفل الذي وُسمَ بالجنون في طفولة المؤلف، نراه يتطرق أيضاً للتنمر الذي يتعرض له بطله الأصمّ، الذي يدرك بأن تحريك شفتيه مثل باقي الأطفال لا يكفيه ليكون مثلهم. في خطوة للاحتجاج يغلق الطفل فمه وينزوي بعيداً عن العالم الخارجي وينقاد لأبيه الذي يريد حمايته وإخفاءه، حتى تبدأ أحداث 2011 في سوريا التي تعيد بطريقة أو أخرى للشاب صوته وصِلته بالعالم. يبدو ذلك مكثفاً بصورة واضحة في إحدى عبارات الكتاب المكتوبة على لسان ي: « صرختُ كي أصرخ، صرختُ كي أثبت للجميع بأنني موجودٌ في العالم، كي أدفن ذلك الكائن الأصمّ في داخلي». فـ «ي» الذي تحرر من خوفه بات موقناً «بأنّ الخوف يلج صُلب الكائنات من آذانها».
كتابة: نور أبو فراج | تم إنتاج هذه المادة بالتعاون مع موقع الجمهورية