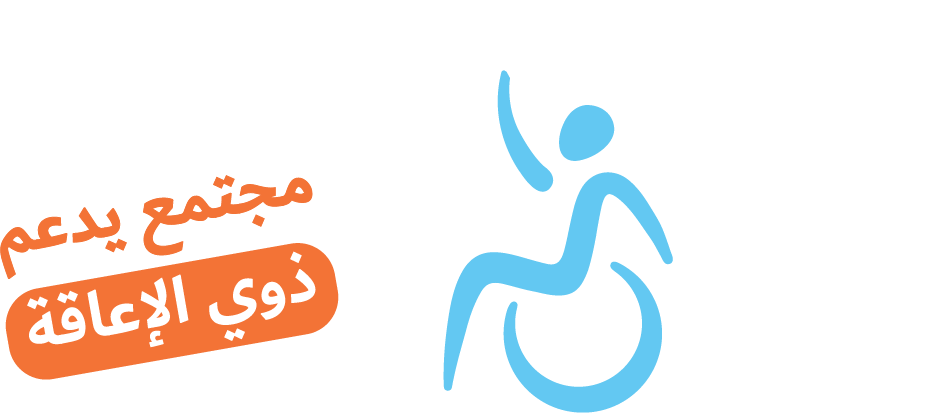تتعرض النساء والفتيات ذوات الإعاقة -بحسب المنظمة العالمية لتمكين المرأة (WEI)- إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي بما لا يقل عن ضعفين إلى ثلاث أضعاف العنف الذي تتعرض له باقي النساء، ومن الواضح أنهن يتعرضن لأشكال مختلفة من التمييز نتيجة لإعاقتهن، ومن سوء المعاملة خلال فترة زمنية أطول، وعقبات أكثر تعقيداً تمنعهّن من تجاوز التعنيف والسعي للعدالة.
العنف القائم على الإعاقة قد يأتي من الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة، وكذلك من مقدمي الرعاية والخدمات الطبية، أو أرباب العمل وأصحاب السلطة وغيرهم. ويشمل هذا العنف منع الدواء أو الأجهزة المساعدة، وتقديم الرعاية دون المستوى المطلوب، والحرمان من الحقوق الأساسية بما فيها العزل القسري وتقييد وسائل الاتصال مع العالم الخارجي.
أما النظم الأبوية والسلطوية فكثيراً ما تجرد النساء ذوات الإعاقة من الأهلية القانونية والحق في اتخاذ القرار، مما يجعلهن أكثر عرضة للإجراءات الطبية القسرية في بعض الأحيان متل منع الحمل أو الإجهاض.
وكما هو الحال عند معظم النساء تعجز ذوات الإعاقة ترك المعنّف أو الإبلاغ عنه بسبب اعتمادهنّ العاطفي والمالي عليه في بيئة غير داعمة لحقوقهن، أو لأنهن قد يتعرضن لعواقب وخيمة بعد الإدلاء بشهادتهن؛ ومما يفاقم الوضع أكثر أن الأخصائيين الاجتماعيين غالباً ما يفتقرون إلى التدريب اللازم للتعامل مع الفتيات اللواتي يتعرضن للعنف القائم على الإعاقة.
تخشى النساء المعوقات أيضاً من فقدان حضانة أطفالهن إذا ما أبلغن عن العنف المنزلي، لوجود صورة نمطية لدى الأجهزة القضائية بأن الشريك غير المعاق هو الأكثر أهلية بالضرورة، ومن غير المرجح أن تأخذ المحاكم تلك الشكاوى على محمل الجد مما يشجع الجناة على المزيد من العنف.
كما لا تتوفر في مراكز الشرطة أو المراكز العدلية الموارد اللازمة لضمان قدرة الشهود من ذوي الإعاقة على التواصل وتقديم الشهادات (مثل مترجم لغة إشارة، قوانين مطبوعة بلغة البرايل، إمكانية الوصول الفيزيائي، …) مما يمنع الكثير من النساء ذوات الإعاقة على فهم حقوقهن أو متابعة شكواهن.
وهكذا تُترك تلك النساء من دون أي حماية حقيقية ومباشرة، فالقوانين والسياسات وحتى برامج المساعدات الإنسانية نادراً ما تعالج المخاوف الخاصة بذوات الإعاقة، مما يزيد من الصور النمطية والوصمة التي تعزز هذا العنف ضدهنّ!