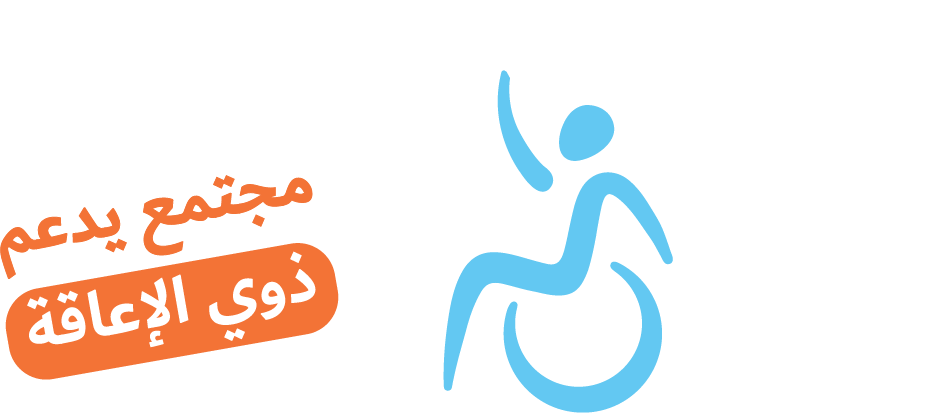بعد معاناة طويلة في المواصلات العامة، وصلت أخيراً إلى بوابة الجامعة. تلاشت الدقائق بسرعة كبيرة ولم يتبقّ إلا لحظات معدودة قبل أن يبدأ الامتحان.
كنت أفكر كيف سيكون الشخص الذي سيكتب لي؟ هل سيكون خطه جيداً أم رديئاً؟ سريعاً بالكتابة أم بطيئاً؟ أسئلة عديدة كانت تشغل تفكيري، لا سيما أن إدارة الجامعة ترفض أن أكتب بلغة البرايل التي نستخدمها نحن المكفوفين.
دخلت إلى قاعة الامتحان وطلبت من المراقب أن يحضر لي شخصاً ليساعدني في إجراء الامتحان، فعبّر عن استغرابه قائلاً: “أليس لديك يدين لتكتب”، ثم أدرك الموقف ومضى وهو يردد بصوت منخفض: “الحمد لله على الصحة والعافية”!
وبعد انقضاء 15 دقيقة من وقت الامتحان، جاء أحدهم وبدأنا فوراً بملئ المعلومات الأساسية في ورقة الامتحان مثل الاسم والتاريخ، علنا نستدرك الوقت الضائع. بعدها بدأ الشخص برمي أسئلته التي لا تنتهي: ألم تستشر طبيباً؟ فأكدت له أني فعلت، لكن لا علاج لحالتي. أخذت نفساً عميقاً، وطلبت منه أن يقرأ السؤال الأول.
لكنه تابع أسئلته: هل جربت الاستعانة بنظارات؟ ترددت قليلاً، ثم أجبته بأن النظارات لا تفيدني. وتوالت الأسئلة: كيف تدرس؟ هل يساعدك أحد؟ كيف ستعود إلى بيتك؟ هل لديك أخوة مثل حالتك؟ كيف وصلت إلى هذه الحالة؟
لم يكن يهمني حينها سوى الوقت الذي كان يضيع مني. سألته: “كم تبقى من وقت الامتحان؟” فأجابني بتهكم ألا أهتم بذلك لأنني بكل الأحوال لن أعرف الإجابات! حاولت تجاهل استخفافه لأنني كنت مصمماً على التركيز في الامتحان.
وبعد أن انتهينا من الإجابة على السؤال الأول، قرأ لي السؤال الثاني، فأجبته مباشرة. لكنه أوقفني ليخبرني أن إجابتي خاطئة، وأنه سيكتب لي الإجابة الصحيحة حتى أجتاز الامتحان بنجاح!
رفضت اقتراحه وأخبرته بثقة أني متأكد من إجابتي. لكنه لم يستجب، واستمر بكتابة إجابته التي لم أعرف ما هي حتى الآن! وبعد انتهاء الوقت، أعطاني رقمه وطلب مني ساخراً التواصل معه ليعرف “درجته” في هذه المادة!
في الواقع، لم تكن تهمني تلك الدرجات الامتحانية، بقدر ما كان يهمني شيئاً واحداً فقط، أن أقدم امتحاناً بطريقة عادية دون أن يتدخل أحد بحياتي الشخصية، ودون أن أطلب مساعدة تقلل من قدراتي وتستهين بمهاراتي!
تجربة: مالك سليمان
تم إنتاج هذه المادة بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية.